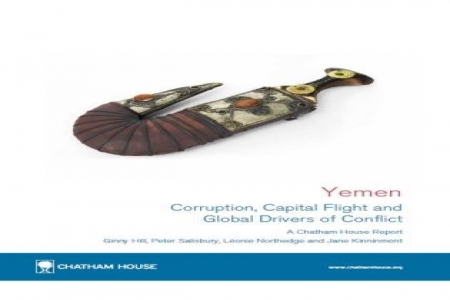
بينهم "صالح" و "محسن".. عباقرة فساد في اليمن بشهادات دولية
نشرت "الأولى" مقتطفات من تقرير مطول للمعهد الملكي للسياسات الدولية، والذي نشره المعهد أمس الأول، بعد أن كانت الصحيفة قد نشرت خبر عنه. وركزنا في نشرنا لهذه المقتطفات على تسليط الضوء على الجانب الإقتصادي وما رافقه من عبث أدى بالبلاد إلى ما هي عليه الآن.
وقد تضع مقتطفات هذا التقرير، المواطن المطلع على أمام وقائع زمنية متسلسلة إلى الآن، إلى جانب شخصيات وشركات شاركوا بشكل كبير في إنهاك الدولة اليمنية، وأسقطوا مشروعية كيانها.
ملخص إجرائي:
يعتبر اليمن أفقر بلد في الشرق الأوسط، وأهمية دراسته لأي شخص هي محاولة لفهم التحولات السياسية المعقدة في حركة "الربيع العربي"، وكذلك لفهم السياسات الدولية لـ"الحالة الهشة" و"الحرب على الإرهاب".
وبموجب التسليم التفاوضي سلم الرئيس علي عبدالله صالح السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، في نوفمبر 2011، بعد 3 عقود من بقائه في سدة حكم جمهورية عسكرية. وجنب هذا التسليم البلد خطر الحرب الأهلية، في حين تم وضع إطار للإصلاح على المدى البعيد. وقد حدت هذه التحولات ببعض المراقبين إلى ذكر المرحلة الانتقالية في اليمن على أنها قصة نجاح إقليمية، كما أشاروا إلى أنه يمكن تقديم اليمن كنموذج للدول المتضررة من النزاع، بما في ذلك سوريا.
وبالرغم من أن نتائج المرحلة الانتقالية لا تزال غير مؤكدة؛ وبعيدا عن اعتبارات أن البلد يمضي بضمانات على طريق المستقبل المزدهر الآمن، يواجه اليمن مخاطر جدية من عدم الاستقرار السياسي، إلى جانب أزمة الموارد التي تلوح في الأفق، كما أنه مجبر على استنفاد احتياطاته من النفط التي تدعم الموازنة العامة للدولة.
وبالرغم من الجهود المتضافرة من جانب الجهات المانحة لدعم التنمية والمساعدة في تعزيز برنامج إصلاح الحكم خلال العقد الماضي، لا تزال معدلات الفقر والجوع عالية بشكل لا يصدق.
ويقدر برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من 10 ملايين يمني (46% من السكان) ليس لديهم ما يكفي من الطعام. ويفاقم هذا الوضع سلوك الإثراء الذاتي للنخب السياسية في البلاد، والتي تستنزف موارد اليمن من خلال التكسب غير المشروع وإرسال الأموال المعفاة من ضريبة الأرباح إلى الخارج، وغالبا ما تنشط بشدة مقاومة الإصلاحات الهيكلية التي يكون البلد بأمس الحاجة إليها.
وتتم هذه الإصلاحات بناء على خارطة طريق انتقالية تتكون من مؤتمر الحوار الطموح، وإعادة هيكلة الجيش، والإصلاح الدستوري. ومن المقرر أن تنتهي هذه العملية بانتخابات في العام 2014، وتمثل هذه الانتخابات فرصة تاريخية لإعادة النظر في بنية الدولة.
إن بروز النساء والرجال في الحوار، جنبا إلى جنب مع القوى الاجتماعية والسياسية التقليدية، يعتبر سابقة هامة لإدراج قوى سياسية أكثر نطاقاً. وعلى أي حال، بناء الشرعية عمل طويل ومعقد، وينجز تسوية سياسية جديدة قد تكون مستقرة، ولكن غير مضمونة النتائج.
ومثل العديد من قيادات المرحلة الانتقالية التزمت الحكومة المؤقتة إصلاحات سياسية واقتصادية، ولكن قد يدفعهم الصراع لواجهة المقاومة الناتجة عن مصالح النخبة الحالية. وفي الواقع فإن العديد من اليمنيين يتساءلون هل الاتفاق السياسي يمثل بداية مفاوضات تاريخية لمدخل سياسي جديد، أم أنه تم تصميمه لإخفاء السلطة والثروة التي يحتفظ بها أعضاء النخبة السياسية الحالية. وهذه الحالة ليست فريدة في اليمن، حيث يستمر النقاش حول ما إذا كانت إدارة الرئيس المصري السابق محمد مرسي هي ذاتها التي عرقلت الإصلاحات، أم أنها منعت من قبل المصالح السياسية المتعارضة التي توقف الدعم عنها.
وقد دعمت وتوسطت لنقل السلطة من صالح إلى هادي، جهات فاعلة خارجية مثل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، في محاولات منها لضمان الرقابة على الانتقال، وللمشاركة بشكل كبير في تنفيذه يوما بعد يوم.
وتعمل المرحلة الانتقالية في الحقيقة على دراسة إمكانية وضع أساس لترتيب سياسي مسؤول وأكثر شمولاً، والذي مع مرور الوقت سيبدأ بعملية تحول موازٍ في الاقتصاد السياسي. لكن تحقيق هذه الوعود في الواقع سيتطلب بحق مشاركة دولية رفيعة المستوى تتجاوز التمثيل الدبلوماسي التقليدي.
ومع ذلك، تشكل الجهات الخارجية قوتين تعملان على حد سواء، قوة دافعة للاستقرار وعامل خطر، خاصة عندما يكون تدخلهم مدفوعا بأولوية سياسة مكافحة الإرهاب قصيرة المدى، والتي تتعارض مع تصورات اليمنيين للشرعية، وأحيانا، وكما في حالة الاستراتيجية الأمريكية لسلاح الطائرات بدون طيار، والتي تقوض مشروعية هذا التدخل بشكل مباشر، خاصة وأن أولوية المانحين في إنفاق مساعداتهم، تذهب تقليدياً للمساعدات العسكرية.
الاستراتيجية ذاتها التي تبعث برسائل إلى قادة اليمن حول أولويات شركائهم الدوليين، والتي يتوقعون منها الدعم ومتابعته.
الاقتصاد السياسي في عهد صالح
عندما تولى صالح الرئاسة، العام 1978، كانت الجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن آنذاك)، عبارة عن جغرافيا وأراضٍ متنوعة اجتماعيا، وحكمت من قبل الدولة المركزية في صنعاء. وكان الاقتصاد يعتمد على الزراعة والواردات والصناعات المحلية والتحويلات الخارجية وغير الرسمية، وشبكات مركزية أخرى للتمويل.
وقد منحت السلطة شرعيتها في الدولة المركزية من قبل شبكة متنوعة من الجماعات القبلية المتسيدة على المستوى المحلي.
تصرفت الدولة كوسيط في النزاعات المحلية، بدلا من أن تكون سلطة مركزية التي تفرض سلطة القانون بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد. وعلى مدى 3 عقود، عمل نظام صالح على "مركزة" توزيع السلطة والثروة.
وبدلا من بناء المؤسسات الرسمية للدولة الوليدة، حيّد صالح القادة المحليين المنافسين والأقوياء بشبكة رعايا آخرين يعتمدون على ريع النفط، وصولا إلى الفرص التجارية المشروعة وغير المشروعة، وتم تهميش الدوائر المحلية على نحو متزايد، واستخدمت تكتيكات "فرق تسد" لضمان أن قوة القيادة المركزية لا يمكن الطعن بها.
سلطة العائلة
ارتكزت هياكل السلطة على علاقات الدم والزواج في وقت مبكر من نظام الرئيس صالح، مع قبيلته سنحان، التي جاءت للسيطرة على القوات المسلحة، ووصل النظام إلى قوته بموجب اتفاق ضمني لتقاسم السلطة مع حاشد، اتحاد القبائل الأكثر أهمية في اليمن، والتي تعتبر سنحان جزءاً منها، وكان يرأسها في ذلك الوقت الشيخ عبدالله الأحمر.
زوّج الشيخ عبدالله وصالح أقاربهم من أعضاء بارزين في حاشد، في حين بنى صالح علاقات متينة جدا مع أسر قبلية ودينية. زوج الشيخ عبدالله أيضاً بناته على أعضاء في قبيلة بكيل، التي كانت قبل مجيء صالح لها حضور مهم في الجيش، إلى جانب عائلات تجارية من شمال اليمن، كتعز وإب والحديدة.
علاقات الزواج هذه أبرزت المصادر الرئيسة للسلطة في الاقتصاد السياسي لعهد الرئيس صالح:
الجيش هيمن عليه حلفاء صالح في سنحان، وأبرزهم اللواء علي محسن الأحمر، وفي ما بعد ابنه أحمد علي، والذين كوّن من خلالهم جزءا كبيرا من نشاطه الاقتصادي غير المشروع، إلى جانب تدفق الأموال من نشاط المحسوبية.
القبائل مع قيام كل من صالح والشيخ عبدالله بدور وسطاء ومحاورين رئيسيين باسم النظام.
الدولة التي تتألف من وزارات حكومية ومؤسسات يشرف عليها اسميا وزراء تكنوقراط، ولكن في نهاية المطاف موجهة من قبل صالح، جنبا إلى جنب مع أعضاء من حزب المؤتمر وحزب الإصلاح، الذي أسس من قبل الشيخ عبدالله، العام 90.
الاقتصاد، الذي أصبح على مدى عمر النظام يعتمد، وبشكل متزايد، على الواردات المدفوعة من المال الناتج من أموال النفط.
النفط والمحسوبية
كان أكثر ما يشد الانتباه بالنسبة للتنافس الاقتصادي في عهد صالح، صناعة النفط والغاز، والتي تعتبر المصدر الرئيس لعائدات التصدير والتمويل الحكومي، مما جعل صالح يعطي لنفسه الأمر والحكم النهائي في هذا القطاع، ومنها الموافقة على جميع الصفقات الكبرى واتفاقيات تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الدولية، التي تم منحها امتيازات في اليمن.
إن احتكار الحكومة اليمنية لشركات البترول والسيطرة على استيراد وتوزيع المنتجات البترولية، وتفويض امتيازات هذا الاحتكار لاثنين من المشغلين الرئيسيين: توفيق عبدالرحيم وأحمد العيسي، وكان كل من الرجلين تربطهما علاقات وثيقة مع صالح وعلي محسن (الذي هو نفسه استفاد من فاعلية الاحتكار على استيراد السلع من قبل شركة النفط من خلال شركته (ذكوان للبترول والخدمات المعدنية). كما تدور الممارسات الفاسدة في قطاع النفط حول خصخصة عقود الخدمات وصفقات الاستيراد والتصدير. صالح أيضا خصص منتجات الوقود المدعوم من قبل الدولة كحصص لأقاربه وحلفائه السياسيين، الذين كان يتردد -عند توجيه أصابع الاتهام لهم- أنهم كانوا يقومون بشحن شحنات كبيرة من البترول إلى المشترين المحليين بالجملة، والذين يتاجرون بالحصة المخصصة للسوق المحلية لبيعها في الخارج وبأسعار السوق الدولية.
سمح الرئيس أيضا لرجال الأعمال المقربين بادعاء أحقيتهم في الإعانات المالية الناتجة عن استيراد الوقود غير الموجود، وعلى أساس من وثائق استيراد مزورة، وهذه الممارسات أثبتت بشكل كبير أنها مكلفة على الدولة. وكانت "المؤسسة الاقتصادية اليمنية" التي يديرها الجيش، بين المستفيدين من هذا التعامل. وكان الفساد المتعلق بالنفط متوطناً أيضا في الجيش، حيث يستفيد الضباط مباشرة من الوقود المخصص لوحداتهم العسكرية، واستخدام البنية التحتية لنظام النقل العسكري للتنقل داخل اليمن وفي الأسواق الخارجية.
إطار رقم 1: (دراسة إحدى حالات الفساد): شركات "Schlumberger" و"Dhakwan" و"Zonic"
أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في 2010، أن وزارة العدل الأمريكية تحقق في خدمات شركة "Schlumberger" النفطية، والفساد المتعلق بعملها في اليمن, حيث إن الشركة تقدمت بعروض في عام 2002 لإنشاء بنك معلومات لجمع المعلومات حول الحقول النفطية في اليمن، المدارة من قبل شركة "PEPA" الحكومية للتنقيب عن البترول وهيئة الإنتاج، وتستخدم الشركة وكيلاً محلياً، وهو شركة "Zonic"، التي يديرها توفيق صالح عبدالله صالح، وهو وكيل الشركة المحلي.
وقبل التوقيع على الصفقة، دفعت شركة خارجية تابعة لشركة "Zonic"، مكافأة التوقيع على الصفقة مبلغ 500.000 دولار، وحصلت الشركة على مدفوعات أخرى بحوالي 1.38 مليون دولار بين عامي 2002 و2007. وخلال الفترة ذاتها كان اثنان من كبار المسؤولين في شركة "PEPA" الحكومية، وهما أحمد عبدالجليل الشميري، وعبدالحميد المسوري، قاما باستئجار سيارات للشركة، وبسعر أعلى بكثير من سعر السوق. وفي الوقت ذاته، أصبحت شركة "ذكوان" للبترول والخدمات المعدنية، وكيلاً لشركة "PEPA" لتصدير واستيراد المعدات، وتلقت 280.000 دولار بين عامي 2004 و2007، وتأكد أن الذي يملكها علي محسن، من خلال الاتفاق الكتابي. (النفط والغاز قالوا إنه من المستحيل استيراد المعدات إلى اليمن من دون استخدام الوكيل "شركة ذكوان").
ووفقاً لـ"وول ستريت جورنال"، فعندما حاولت "Schlumberger" إنهاء ترتيب العقود مع "ذكوان"، أصبح من المستحيل عليها استيراد المعدات إلى اليمن، وفي إيداع بشهر أكتوبر 2012 في لجنة الأمن والبورصات الأمريكية، لم تقدم "Schlumberger" أية إشارة إلى القضية، ولكن ذكرت أن وزارة العدل "أغلقت تحقيقاتها" في قضية فساد عام 2007.
الجيش
الجيش أيضا، هو وسيلة هامة لتوزيع المحسوبية والتكسبات، مع أشباح جنود، مع تهريب أسلحة ووقود وبشر، كلها لتوفير مصادر دخل مربحة لضباط كبار وشركائهم التجاريين. وعلى الرغم من أن الأجهزة الأمنية سقطت اسميا من إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، فإن كبار القادة الذين جاؤوا من سنحان -قبيلة صالح- تصرفوا فيها بشكل مستقل إلى حد كبير، وكان الجيش حراً بشكل غير فعال، وبعيدا عن الرقابة المدنية، ولذا انتشر الفساد. (مؤشر الشفافية الدولية 2013 صنف وزارة الدفاع اليمنية من بين مؤسسات الدفاع الأكثر فسادا في العالم).
بحلول العام 2010، فإن الجيش يتكون من سلسلة من التحالفات بين فصائل أكثر ما تشبه "إقطاعيات أمراء الحروب الحديثة"، والتي تدير الأمور العسكرية مركزيا. وكان صالح يتخوف من خلق قوة عسكرية مركزية قادرة على شن انقلاب (مثل تلك التي أطاحت –فعليا- بالرئيس المصري حسني في العام 2011). لكن السماح بإبقاء الجيش في حالة انقسام، خلق وضعا جديدا، حيث تصرف أحمد علي وعلي محسن على أنهما مركزا تنافس على السلطة، وكل مع شبكة محسوبيته واسعة النطاق. هذه الانقسامات، التي تضخمت على شكل توترات بشأن توزيع المحسوبيات السياسية والسلطة، ساعدت بوضوح في انشقاق الجيش أثناء العام 2011. كان هذا النموذج يمثل تناقضا صارخا مع مصر التي حاذرها صالح، حيث ظلت القوات المسلحة أكثر توحدا، ومؤسساتها أكثر تماسكا، وأكثر قدرة في السيطرة على العملية الانتقالية.
إن تملك الأراضي يمثل واحداً من أهم المصادر الرئيسية للإيرادات غير المشروعة للقادة العسكريين، ويزعم أن اللواء علي محسن وأحمد علي صالح، مع عدد من القادة الإقليميين الآخرين، كانوا من بين كبار ملاك الأراضي في اليمن. وبحلول العام 2006، ووفقا لهيئة المعونة الأمريكية (USAID)، كانت "YECO" (المؤسسة الاقتصادية اليمنية شبه الحكومية، والتي يديرها ضباط) تحوز على مساحات واسعة من الأراضي والشركات المختلفة شبه الحكومية، وفي المقام الأول في "جمهورية جنوب اليمن السابقة"، وتعمل "YECO" في عدد من القطاعات، بما في ذلك العقارات والسياحة (تمتلك شركة "سناء" المدينة السياحية)، وفي البناء والنفط والغاز والأدوية والنقل والزراعة. وإن ملكية الأراضي التي تحوزها يفتقر تسجيلها إلى الإشهار والشفافية والوضوح، وينتشر فيها الفساد. ومن خلال "YECO" يمكن للجيش حيازة هذه الأراضي، وادعاء استخدامها للأغراض العسكرية، وفي وقت لاحق، يتم توزيعها للضباط، أو بيعها لتحقيق مكاسب خاصة. ويحتفظ كل من صالح وعلي محسن، على حد سواء، بشبكات المحسوبية الواسعة داخل "YECO".
فوائد غير متكافئة لتحرير الاقتصاد
بحلول انتفاضة 2011، تركزت ملكية "صروح شامخة" من اقتصاد اليمن في أيدي نخبة صغيرة. وفي أوائل العام 2011، سيطرت ما يقارب من 10 عائلات على أكثر من 80% من الواردات والتصنيع والتحويل والخدمات المصرفية، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل (وهو الوضع الذي بقي دون تغيير حتى كتابة هذا التقرير).
وأعقب ذلك سنوات من الوعود لتحرير الاقتصاد، والتي إلى حد كبير، إما ذهبت أدراج الرياح دون تنفيذ أو تم استخدامها لتعزيز قوة النخب السياسية والقبلية. وفي العام 1995، دخلت صنعاء في مباحثات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر سلسلة من برامج الدعم المالي، وقدمت المؤسستان قروضاً ومنحاً مشروطة مقابل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الحرة، بما في ذلك تحرير التجارة والأسعار وخصخصة شركات مملوكة للدولة. نفذ التكنوقراط في صنعاء بعض هذه الإصلاحات خلال السنوات القليلة الفائتة من عام 1990، بما في ذلك تحرير القطاع المصرفي ورفع الدعم عن الاسمنت والواردات الغذائية، ولكن لم يشمل هذا الوقود، والذي يعتبر مصدراً رئيساً للفساد والمحسوبية.
شهدت الألفية الجديدة اندماجاً متزايدا للنخبة الصغيرة في اليمن في الاقتصاد العالمي، وبمساعدة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والدفع الغربي للاستثمار في البلاد للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط. ومن الناحية النظرية هدفت سياسات التحرير الاقتصادي هذه إلى إنشاء أسواق توفر فرصاً متكافئة، وتعمل على زيادة المنافسة، وبالتالي سيقود ذلك إلى خفض الأسعار وتحسين مستويات المعيشة، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي. لكن النظام كان قادراً على ضمان توزيع الفرص الاقتصادية الجديدة والتي ظلت إلى حد كبير تحت سيطرته، لاستخدامها في تعزيز مواقفه السياسية لدى القادة الرئيسين وأسرهم، وإلى أعضاء في المعارضة لاستمالتها، واستخدمت في ذلك الفرص الاقتصادية المشروعة وغير المشروعة وتضمنت حصصاً من الوقود المدعومة (النفط) "العرض المحبب" لعقود الدولة لأفراد أسر السياسيين وزعماء القبائل، والذي شكل لهم حافزاً للتعاون مع النظام. هكذا تصرف النظام كمثبط لتحدي الوضع الراهن.
أما الممثلون الذين رفضوا المشاركة في "نظام تقديم الرشاوى" سرعان ما وجدوا أنفسهم منبوذين من الحكومة والشبكات غير الرسمية التي شملها النظام في معظم جوانب الحياة العامة.
استفاد اللاعبون السياسيون والعسكريون والقبليون من عملية تحرير الاقتصاد من خلال الشراكة الناشئة مع عائلات تجارية راسخة. ومع عدم وجود نفوذ عسكري وقبلي للشركات الناشئة لم يكن لها من خيار سوى التعاون مع أعضاء النخبة الرأسمالية الجديدة في اليمن، وكثير منها كان لها تاريخ من التجارة في السوق السوداء والرمادية، من تهريب الكحول إلى تهريب السلاح.
استثمرت الرأسمالية القبلية والعسكرية –والتي استفادت بشكل كبير من السلع الواردة- استثمرت في أحدث آلات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآتية من الخارج، ويتصرف بعضهم كشركاء للشركات الأجنبية التي تتطلع للاستثمار في السوق الصاعدة، وينشئون بنوكاً تسمح بتحويل العملة داخل وخارج البلاد بشكل أكثر كفاءة.
وأكثر المستفيدين كانوا من عشيرة النظام، مثل شاهر عبدالحق، والذي يعتقد أنه منذ فترة طويلة شريك تجاري لصالح وأحد المساهمين في واحد من أكبر البنوك في البلاد، وفي ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول، وفي عدة حقول للنفط ومنجم للزنك.
وكما كان لآخرين علاقات أكثر تعقيداً مع النظام، كانت هناك أكبر الشركات التقليدية التجارية في البلاد والتي تعود بجذورها إلى محافظة تعز، والتي لها مصالح كبرى في الواردات الغذائية والخدمات المصرفية والبناء وقطاع النفط والاتصالات السلكية واللاسلكية. ويتحدث على نطاق واسع على أن هذه الشركات هي من بين الشركات (النظيفة).
ورغم ذلك يحسبون على أنهم حلفاء رئيسون ويشاركون في معظم المشاريع الرئيسة، ويستثمرون أيضاً في خطط تجارية وضعها النظام.
كما تم تعيين أعضاء في عائلة صالح في مناصب مهمة في مؤسسات تديرها الدولة، وأبرزهم (صهره) عبدالخالق القاضي، رئيس مؤسسة اليمنية للنقل (طيران)، التي تديرها الدولة، كما تم تعيين ابن أخيه توفيق صالح عبدالله صالح، رئيساً لمجلس إدارة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، التي تنتج العلامة التجارية الأكثر شعبية من السجائر، و(صهره) الآخر، خالد الرحبي، نط إلى شركة "يمن سبيس"، وهي شركة احتكار الإعلانات التجارية الخارجية (في الشوارع).
الورثة والإصلاح
من بين شركات المقدمة في "الصروح الشامخة" للاقتصاد اليمني، تأتي مجموعة آل الأحمر، وهي مجموعة تجارية شاسعة، وتمثل جزءاً من أشهر الشركات متعددة الجنسيات في العالم، ويملكها حميد الأحمر، نجل الشيخ عبدالله.
ويعتبر حميد جزءاً من جيل "الورثة" الجدد، والذين بدأوا بالظهور من داخل "كونفدرالية حاشد القبلية"، خلال العام 1990، وأصبح في ما بعد أحد أطراف نزاع النخبة في العام 2011. بنى صالح قواعد سلطته الأولية من قبيلته "سنحان" التي أدخلها إلى الجيش.
وعندما توفي محمد عبدالله صالح، في 2001، تولى السيطرة على قوات الأمن المركزي، من بعده، ابنه يحيى. من عام 2001 تعززت سلطات يحيى وأخويه طارق وعمار، بالمساعدات العسكرية، كما قامت بأمنهم قوات من النخبة في وحدات الاستخبارات الممولة والمدربة من الحكومات الغربية. وسيطر الحرس الرئاسي ومكتب الأمن القومي المدعوم أمريكيا، إلى جانب القوات الخاصة التابعة لأحمد علي؛ على الموارد الغربية التي أصبحت جزءاً من الاقتصاد السياسي للجيش، في سياق "الحرب على الإرهاب"، مما أثر على توازن القوى داخل النخبة الحاكمة، من خلال تعزيز ودعم موقف أقارب صالح في الجيش.
استغل هذا الجيل الجديد، أيضا، عملية تحرير الاقتصاد، لبناء مصالح تجارية واسعة، بدءاً من السيطرة على المؤسسات الحكومية. ففي 2008، تحالف أحمد علي مع أنصاره "التكنوقراطيين"، وأسسوا شركة "شبام القابضة"، بوصفها المطور العقاري الداعم للدولة، وذلك بدعم من البنك الدولي.
وأخذت الهيئة الجديدة السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها "المؤسسة الاقتصادية" (YECO)، والمؤسسات الحكومية الأخرى، وتصرفت على حد سواء كشريكة في مشروع مشترك لمطوري العقارات، ومستشارة للحكومة بشأن تنظيم قطاعات العقارات.
وفي وقت لاحق، تمت السيطرة على الهيئة العامة للاستثمار، الجانب الآخر الذي يحقق وظيفة ثنائية تنظيمية واستشارية للمستثمرين.
أثار ظهور "ورثة" سنحان الشبهة بين النخب اليمنية التاريخية، مما جعل "نبلاء" سنحان، الذين كانوا طرفا في اتفاق 1970 الذي جلب صالح إلى السلطة؛ شعروا بالقلق من أن الرئيس كان يعمل على تمكين أسرته على حساب قبيلته الواسعة، بينما مشائخ حاشد، مثل حميد وصادق الأحمر، والذين شهدوا صعود أحمد، اعتبروا الأمر محاولة من صالح لتتويج ابنه لرئاسة الجمهورية. واتهم أحمد علي وأبناء عمومته -حتى من أعضاء في حزب المؤتمر- بتشكيل دولة موازية من خلال الحرس الجمهوري والأمن القومي و"شبام القابضة" وشركات أخرى متحالفة معهم، والبعض منها مدعومة دولياً.
الاستدامة الاقتصادية
وكما أصبح التوتر يبدو واضحاً بين السلطة والشركاء الرئيسيين، من الواضح أيضا أن الاقتصاد اليمني تم وضعه من قبل النظام الراعي على مسار غير مستدام. وبعد أن بلغ إنتاج النفط ذروته عام 200، دخلت البلاد في حيز انخفاض مطرد لهذه الثروة، واستمر تسجيل الحكومة مستويات من العجز المتعاقبة، بسبب زيادة الإنفاق على الجيش والاستمرار في دعم الوقود.
وتمثل إيرادات النفط 80% من إيرادات الحكومة خلال العقد الأول من هذا القرن، كما يمثل النفط 80-90% من الصادرات، بينما ذهب أكثر من ملياري دولار (أكثر من خُمس الإنفاق) للإعانات. وفي 2010، لم يصبح الإنفاق الحكومي يعتمد على النفط فقط، وإنما اعتمدت عليه عائدات البلاد من العملة الأجنبية.
وأدى اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الحكومي إلى قلق المحللين من أن انخفاض إيرادات التصدير من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الاقتصاد، وبالتالي تراجع مماثل للناتج الاقتصادي المحلي على نطاق أوسع، ومن ثم الضغط على الشركات والبنوك المحلية، والتي كانت المصدر الرئيس لتمويل المديونية الحكومية. وتزامن انخفاض العائدات مع ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وبدون مكاسب في الإنتاج، وأصبح البلد عرضة للتحولات في أسعار السلع الأساسية.
وفي الربع الأول من عام 2009، انخفضت إيرادات الحكومة من بيع النفط الخام بنسبة 75% عن العام الذي سبقه، حيث انخفضت أسعار النفط العالمية استجابة للأزمة المالية العالمية، مما دفع الاقتصاد ونظام المحسوبية إلى أزمة مؤقتة.
معضلة الإصلاح
كانت الجهات المانحة لليمن، تدرك المخاطر التي ينطوي عليها انتقال البلاد الوشيك لمرحلة اقتصاد ما بعد النفط، وابتداء من أوائل العام 2000، بدأوا بالضغط على صالح لتنفيذ سلسلة حساسة من إصلاحات الحوكمة السياسية.
وكان صالح يتملص من أي إصلاحات قد تنفذ وتسبب تكلفة سياسية له. ووفقا لبرقية دبلوماسية أمريكية مسربة من العام 2005، فقد فضحت الأساس الهش لصفقات النخبة.
فعندما حاول رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال، الدفع نحو الإصلاحات، خلال تلك السنة، تعرض للاعتداء الجسدي في البرلمان، وكان رفع مفاجئ للدعم في وقت لاحق من ذات العام، أدى إلى أعمال شغب واسعة. ورفض 78 عضوا من التجمع اليمني للإصلاح وحزب المؤتمر، مقترحات باجمال، في إشارة إلى أن الإصلاحات هددت مجموع المصالح بين النخبة السياسية.














